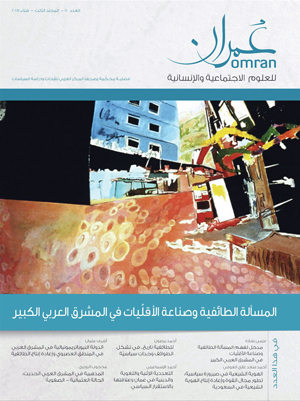
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الحادي عشر من دورية عمران (شتاء 2015)، وهي دورية فصلية محكّمة تعنى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.
وخصصت المجلة محور هذا العدد لموضوع "المسألة الطائفية وصناعة الأقلّيات في المشرق العربي الكبير"، وفيه كتب الدكتور عزمي بشارة ورقة بعنوان "مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة الأقلّيات في المشرق العربي الكبير"، ويبحث في الطائفية بوصفها ظاهرةً حديثةً في سياقٍ أصبحت فيه الطائفة جزءًا من كلٍّ وهو الكيان الوطني أو الدولة. وتقدم الورقة مثالَي لبنان والعراق في رصد تحوُّل الطائفة الاجتماعية إلى طائفة سياسية، وتشير إلى التدين السياسي الذي إذا وقع في مجتمعات متعدّدة الطوائف فإنه يؤُول بالضرورة إلى طائفية سياسية، وذلك في رصد عملية تحويل الجماعات أو الديانات والمذاهب الأخرى وتفكيكها إلى أقلّيات قياسًا بأكثرية طائفية.
كما كتب أحمد بيضون ورقة "للطائفية تاريخ.. في تَشكُّل الطوائف وَحَداتٍ سياسيّة" وتركّز على الجانب المتغير أو المتحوّل في المسألة الطائفية، ويبحث في الحبكات الطائفية القائمة في أقطار مختلفة من المشرق العربي مع تأكيد الاختلاف بينها، ويعالج سبل التنازع والتضامن والتكوين الطائفي الخاص للمجتمعات في المشرق العربي، منتقلًا بين لبنان والعراق وسورية ومصر.
ويركز بحث أشرف عثمان "الدولة النيوباتريمونيالية في المشرق العربي: في المنطق العصبوي وإعادة إنتاج الطائفية" على غياب/ تغييب الدولة الوطنية الحديثة في المشرق العربي لمصلحة نمط آخر من الدولة هو الدولة النيوباتريمونيالية؛ إذ تجري إعادة إنتاج متواصلة للبنى التقليدية وتحويلها إلى شبكات باتريمونيالية. وعوضًا عن تنظيم علاقة دولة - مواطن على أساس مبدأ المواطنة، جرى/ يجري تنظيمها على أساس زبوني وعبر أساليب وقنوات غير رسمية.
ويسعى بحث أحمد سعد غازي العوفي "الهوية الشيعية في صيرورة سياسية: تطور مجال القوة وإعادة إنتاج الهوية الشيعية في السعودية" من خلال الدراسة التاريخية الاجتماعية للحالة الشيعية في السعودية إلى تقديم قراءة علائقية للهوية في مقابل النزعتين الثقافية والبنيوية؛ وهي قراءة تفضي إلى تعاطٍ أكثر تركيبًا للظاهرة.
وفي دراسة "التعددية الإثنية واللغوية والدينية في عُمان وعلاقتها بالاستقرار السياسي"، يحاول أحمد الإسماعيلي مقاربة مسألة التعددية وأثرها في التوازنات السياسية والدينية للمجتمع العُماني، سواء أكانت تعددية لغوية أم تعددية دينية، أم مذهبية أم إثنية، إلى جانب التعددية الثقافية الجغرافية. وتضع الدراسة إشكالية التعددية في سياقاتها الظرفية والمرحلية، سواء التاريخية أو الجغرافية، وتقدم كشفًا أنثروبولوجيًا لأنساق البنى في دولة خليجية قلّما اشتغلت الدراسات المعرفية بها.
ويُختتم محور العدد ببحث لمحجوب الزويري "المذهبية في المشرق العربي الحديث: الحالة العثمانية – الصفوية" الذي يسعى إلى دراسة تأثير الاختلاف المذهبي في العلاقة بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية، فيركز على سلوك الدولتين بعضهما تجاه بعض، والنحو الذي تطورت فيه علاقاتهما، وهل تأسست الخصومة أو العداوة على أساس التباين المذهبي أم أنّ هناك عوامل أخرى كانت تتفاعل مثل البُعد القومي والتنافس على الجغرافيا؟
وفي باب مقالات ومناقشات كتب إميل بدارين مقالًا بعنوان "فرص بناء أفق سياسي تعددي في دول الثورات العربية"، فيما كتب فوزي بوخريص "حصيلة السوسيولوجيا في المغرب وسؤال النوع: رصد لأهم التحولات". وفي باب مراجعات الكتب كتب خضر زكريا مراجعة لكتاب "الظواهر القبلية والجهوية في المجتمع العربي المعاصر" الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للكاتب محمد نجيب بوطالب، وكتب يحيى بولحية مراجعة لكتاب "أصول التحديث في اليابان 1568-1868" للكاتب محمد أعفيف، كما كتب أحمد عبد الموجود الشناوي مراجعة لكتاب "المعوقات الثقافية للتنمية بالمجتمعات الصحراوية في مصر".
ويختتم العدد بمجموعة من عروض الكتب، فكتب مراد دياني عرضًا لكتاب "العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية، مع اهتمام خاص بحالة مصر وثورتها" لإبراهيم العيسوي، كما كتبت دينا قدومي عرضًا لكتاب "العيش والموت رجلًا، ديناميات النوع الاجتماعي في مدن مصر".
للحصول على أعداد المجلة (نسخ ورقية أو إلكترونية) أو مقالات مفردة منها، أو الاشتراك السنوي فيها، زرّ المكتبة الإلكترونية للمركز.